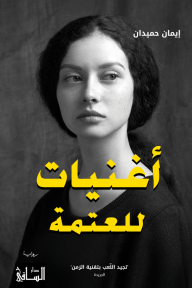رواية جميلة جداً للنساء وعن النساء. عن الضغوط التي تتعرض لها النسوة في ظل أنظمة ذكورية متعنتة لا تراعي احتياجات النساء وأحلامهن. أنظمة تفرض عليهن حيوات وأنماط معيشية تقتل أحلامهن، فيكون مصيرهن كما قالت إيمان حميدان في نهاية عملها الشجي: ❞ هكذا نحن نساء عائلة الدّالي: نرحل، أو نصمت، أو نجنّ، أو ببساطة نموت قبل الأوان كأزهار الكرز ❝
أغنيات للعتمة > مراجعات رواية أغنيات للعتمة
مراجعات رواية أغنيات للعتمة
ماذا كان رأي القرّاء برواية أغنيات للعتمة؟ اقرأ مراجعات الرواية أو أضف مراجعتك الخاصة.
أغنيات للعتمة
مراجعات
كن أول من يراجع الكتاب
-
Haneen Al Sayegh
❞ هكذا نحن نساء عائلة الدّالي: نرحل، أو نصمت، أو نجنّ، أو ببساطة نموت قبل الأوان كأزهار الكرز ❝
رواية جميلة وسرد سلس. شكرا إيمان
-
Shimaa Allam
❞ هكذا نحن نساء عائلة الدّالي: نرحل، أو نصمت، أو نجنّ، أو ببساطة نموت قبل الأوان كأزهار الكرز ❝
عن النساء في لبنان كان هذا العمل من الجدة ، للإبنة ، للحفيدة أسمهان نتعرف على عائلة الدالي و حكايات نساءها ، في خلال فترة زمانية طويلة تبدأ من عام ١٩٠٨و حتى ما بعد عام ١٩٨٢ ، فترة كان تاريخها السياسي خلفية لأحداث العمل .
رواية مليئة بمشاعر و أفكار النساء ، الأحلام ، الوطن ، الحب ، و القدر .
قراءات_وترشيحات #كتب_في_كتب
#روايات_عربية #روايات_مترجمة
#أغنيات_للعتمة
#إيمان_حميدان
#قراءات_٢٠٢٥
-
Nora Khaled
أحببتها ليس فقط لجمال السرد وعذوبة اللغة بل ولأنها عن المرأة، أجيال من النساء ومعاناة الحب والحرب والحرية، معاناة الوجود وإثبات الذات. هل تنتقل المأساة عبر الجينات أو كما يسمونها كارما الأجداد! تساؤل تراوى لي حين أنهيت قراءة الرواية.
-
Mohamed Metwally
قراءات القائمة الطويلة لبوكر ٢٠٢٥
❞ ”تجري حيواتنا وتأخذ طرقات لم نتوقّعها، نفتش عن الأمل ولا نجده. نكتشف أننا أضعناه على الطريق“ ❝
❞ البلد كله قام على حسابات خاطئة من حسابات العثمانيين لحسابات الأتراك لحسابات الفرنسويّة لحسابات موارنة الاستقلال لحسابات الأحزاب السياسية لحسابات رؤساء الجمهورية. قل لي مين حساباته كانت صح؟ ❝
الرواية لها بعدين بيمثلهم الاقتباسين دول، الأول والأساسي هو قصة الأربع نساء على مدار أربع أجيال متعاقبة من أسرة واحدة يشتركن كلهم في خيبة الأمل وضياع العمر بحثا عن ما يملأ خواء القلب من عاطفة أو شريك حياة يحترم، يقدر، ويعين شريكه على تحقيق أحلامه وذاته.
البعد الثاني هو أيضا عن خيبة الأمل ولكن من النوع السياسي، فعلى مدار الأحداث التي تبدأ قبل الحرب العالمية الأولى وتنتهي مع اجتياح لبنان في الثمانينيات، تمر لبنان بسلسلة من الصراعات الخارجية مع المحتل تليها النزاعات الداخلية الطائفية بعد رحيل الانتداب الفرنسي، ومع نهاية كل مرحلة من الصراع بدلا من تبدأ مرحلة البناء والإستقرار يجد لبنان أنه على أعتاب صراع جديد، والكل في النهاية هو الخاسر.
بناء الرواية وتشابك الحكي بين البعدين بسلاسة في سردية مدمجة ومستمرة بدون الحاجة الى التنقل بين حياة شهيرة ونسلها وبين تحولات البلد الساسية كانت من نقاط القوة للكتاب، لكن دسامة العمل وطول الفترة الزمنية استوجبت استخدام الأسلوب التقريري في الكتابة والحاجة الى التركيز مع عدد كبير من الشخصيات على مدار أربع أجيال متعاقبة.
محمد متولي
-
Marwa Abdullah
تمّت في ١٠ فيفري ٢٠٢٥
عن نساء عائلة الدالي، وجعهنّ وحزنهنّ وتجاربهنّ الصاخبة بالألم..
صورت لنا '' اسمهان '' حياتهنّ بدءا بالجدة الأولى شهيرة، ثم ياسمين فـ ليلى..
لكل منهن تجربة مختلفة التفاصيل لكن متشابهة الألم..
حُبّ مبتور، زواج مُدبّر، حرب وتهجير.. و بين كل ذلك يتربص الموت بهنّ في كل مكان..
أحببت الرواية كثيرا، مثلما دائما ما أحب الأدب المعزول بأنامل المرأة عن المرأة..
-
Ola Shami
كتاب جميل جدا يواكب تاريخ لبنان منذ الحرب العالمية الأولى عبر قصص ٤ نساء.
""ريتني حبة ملح وبذوب وما يشوفني حدا". ذابت أمي وبكيت أنا."
"لم ترغب منى في ترك بيروت، لكن في النهاية سافرت على طريقتها. سافرت وبقيت في المكان نفسه. فقدت ذاكرتها. فقدان الذاكرة هو سفر بمعنى ما."
-
نجيب عبد الرازق محمد التركي
"أغنيات للعتمة" ل (إيمان حميدان): بين الألم والسرد والتمرد
نجيب التركي
مدخل: ألم مستعاد، غواية متجددة
عند الانتهاء من قراءة رواية ما، قد تتلاشى بعض النصوص سريعًا، بينما تظل أخرى محفورة في الذاكرة، كوشمٍ لا يُمحى. وهذا ما حدث معي بعد أغنيات للعتمة لإيمان حميدان (دار الساقي، الطبعة الأولى 2024). تمامًا كما بقي الألم الذي سبّبته لي ميثاق النساء لحنين الصايغ، وجدتني، وكأنني تحت تأثير غواية خفية، أُسلم نفسي إلى ألمٍ آخر، مختلف في طابعه لكنه لا يقل عمقًا. لم تكن مجرد قراءة، بل تجربة غمرتني، أخذتني إلى فضاء زمني متشظٍّ، حيث يتداخل السرد بالحقيقة، ويعانق الماضي الحاضر، بينما تتكرر المصائر، كأنها تعيش تحت سلطة قَدَر غير مرئي.
العنوان والغلاف: دلالات أولية
العنوان وحده يكثّف المفارقة المركزية للرواية، حيث يحمل العنوان طابعًا شعريًا يثير التأمل: "أغنيات" توحي بالحياة والبوح، لكنها تأتي "للعتمة"، وكأننا أمام فعل غنائي مقاوِم، صوت يحاول اختراق السكون والظلام.
الغلاف، يتسم بتصميمه البسيط القوي، فهو يحمل دلالات بصرية وعاطفية متشابهة تتماشى مع أجواء الرواية. حيث يأتي بالأبيض والأسود، إذ ترينا صورة جانبية لامرأة نصف وجهها في النور،والنصف الآخر في الظل، ذات نظرة شاردة، في انعكاس بصري لحالة الانشطار التي تعيشها شخصيات الرواية بالتأمل وربما بالحزن الدفين. وهذا يعكس الصراع الأزلي بين النور والظلام، بينما تبرز الكتابة الصفراء كعنصر دلالي يوحي بمحاولة اختراق العتمة، وربما بإنذارٍ خفيّ يلوح في الأفق.
صدمة البداية: السرد كمرآة للاضطراب
بعد تجاوز الإهداء والاقتباس، وجدت نفسي في مواجهة الصفحة الأولى من الرواية، حيث فرضت السوداوية حضورها الطاغي، منذ اللحظة الأولى. لا فسحة للأمل هنا، بل اختناق نفسي يسري مع كل جملة. البداية صادمة ومشحونة بالتوتر، حيث يبدو الرحيل هو الحدث الأول، لكنه ليس مجرد انتقال جغرافي، بل هروب اضطراري، أشبه بفعل نجاة من واقع يضيق على البطلة ويخنقها.
الخوف ليس مجرد إحساس في هذه الصفحة، بل يكاد يكون شخصية خفية تلاحق البطلة وتدفعها لاتخاذ قراراتها. تكراره المكثف يعكس اضطرابها العميق، بل ويؤسس لأحد محاور الرواية الرئيسية: العجز أمام الظلم، حتى حين تمتلك أدوات الدفاع عن النفس. تشعر البطلة بأن العائلة، القانون، والمعرفة كلها لم تحمها، وكأنها تُركت وحيدة في مواجهة قسوة العالم.
"بت أشعر بالغربة والحنين معًا وأنا في بيروت"—هذه الجملة أيقظت في ذهني صدى أبيات البردوني:
"كأنني خارج التاريخ منفردٌ
كأنني آخر الأحياء في وطني"
ليست الغربة هنا مجرد ابتعاد جغرافي، بل حالة من الانفصال الداخلي عن المكان، عن الوطن الذي لم يعد كما كان. البردوني، في قصيدته عن صنعاء، عبّر عن هذا الشعور ذاته:
"صنعاءُ ماذا؟ لستِ صنعاءَ التي
كانَتْ تُسمى في الظلامِ منارا"
وكأن الرواية والشعر يتقاطعان هنا، حيث يتحول الوطن إلى فضاء للخسارات المتكررة، تمامًا كما تقول البطلة:
"بات الشعور بالخسارة العمود الفقري لحياتي. الخسارة كل لحظة: أمام طريق يحتلها رجال الميليشيات، أمام طفل وحيد، قطة جائعة، بيت دمره القصف، شارع مظلم، نشرة أخبار قاتلة، جثث تعرضها الشاشات بلا قلب...."
التقنيات السردية: اضطراب الزمن والمشاعر
تعتمد الرواية على أسلوب سردي يتجاوز التقاليد الكلاسيكية، حيث تُلقى الأسماء والعلاقات دفعة واحدة دون مقدمات، في انعكاس واضح للفوضى الداخلية التي تعيشها البطلة.
يمكن قراءة هذا الأسلوب من منظورين:
1. إيقاع مضطرب يعكس الحالة النفسية: البطلة تتحدث وكأنها تسابق الزمن، تُسقط الأسماء والعلاقات دون ترتيب، كما لو أنها تكتب من داخل عاصفة مشاعرها الخاصة.
2. كسر التقاليد السردية: بدلاً من تقديم الشخصيات تدريجيًا، تُقحم الرواية القارئ مباشرة في قلب المشهد، وكأنها تجبره على مشاركة هذه الفوضى الشعورية. هذا الأسلوب قد يكون مربكًا في البداية، لكنه جزء من تجربة الرواية، حيث تكتشف الشخصيات والعلاقات تدريجيًا، كما تكتشف البطلة ذاتها.
الفضاء الزمني: بين الذاكرة والتكرار
الرواية تتلاعب بالزمن بطريقة تجعل القارئ غير قادر على وضع تسلسل زمني دقيق للأحداث. هناك انتقالات مستمرة بين الماضي والحاضر، دون أن يكون أحدهما هو المسيطر على الآخر. كأن الزمن في أغنيات للعتمة ليس خطيًا، بل هو أقرب إلى ذاكرة مفتوحة تتدفق بحرية، مما يعكس حالة الشتات التي تعيشها الشخصيات.
هذا التداخل الزمني يعزز الإحساس بأن الشخصيات عالقة داخل حلقة من التكرار، حيث تعيش النساء المصائر ذاتها، ولو بأشكال مختلفة. فليلى، بطلة الرواية، تبدو وكأنها امتداد لأمها وجدتها، تعيش ما عاشته النساء قبلها، وتواجه القيود نفسها، وكأن الزمن لم يتحرك إلا في شكله الظاهري.
مسألة التقمّص: أين تبدأ الذات وأين تنتهي؟
إحدى أكثر الأفكار إثارة في الرواية هي مسألة "التقمّص"، ليس بالمعنى الصوفي، بل في المعنى النفسي والاجتماعي. الشخصيات تعيش حيوات غيرها داخل نفسها، سواء بوعي أو بدونه. ليلى تحمل داخلها صوت أمها وتجاربها، تمامًا كما تشعر ياسمين (الأم) بأنها عالقة في إرث النساء السابقات.
هذا التقمّص لا يتوقف عند الشخصيات، بل يمتد إلى النص نفسه. فنحن، كقرّاء، نجد أنفسنا أحيانًا غير متأكدين: هل تتحدث ليلى عن نفسها أم عن أمها؟ هل هذا الحدث وقع فعلًا أم أنه إعادة سرد لحكاية سابقة؟ هذا التداخل بين الشخصيات يجعل الحدود بين الذات والآخر غير واضحة، كأن الشخصيات تتبادل الأدوار دون وعي منها.
الإسقاطات: بين الأدب والواقع السياسي
الرواية تحمل مستويات متعددة من الإسقاط، تتجاوز الحكاية الفردية إلى أبعاد سياسية واجتماعية أوسع. بيروت ليست مجرد مكان تجري فيه الأحداث، بل هي كيان متحول، يعيش داخل الشخصية بقدر ما تعيش هي داخله. بيروت هنا هي مدينة الحرب والانقسامات، لكنها أيضًا مدينة الأحلام المجهضة.
هذه المدينة التي بدت "أوسع عالم يمكن للإنسان أن يعيش فيه"، هي ذاتها التي تحولت إلى سجنٍ كبير بفعل الحرب والخوف.
التتابع الرمزي والاستطراد الحكائي
تعتمد الرواية على تقنية "التتابع الرمزي"، حيث تتراكم العناصر الصغيرة—طفل يتيم، قطة جائعة، شارع مظلم—لتشكل في النهاية صورة أكبر، صورة عالم مشبع بالخسارات. وهذه إحدى أبرز تقنيات الرواية، كما أن الاستطراد الحكائي تتوالى فيه الأحداث ليس فقط بناءً على التسلسل الزمني، بل وفقًا لروابط رمزية وإيحائية تجعل من كل حدثٍ امتدادًا لما قبله. هذا الأسلوب يجعل الرواية تبتعد عن السرد التقليدي، كما أن هذه التقنية تعمّق الأثر النفسي على القارئ، إذ لا تُطرح القضايا مباشرة، بل تتسلل عبر المشاهد اليومية، فتترك أثرًا أقوى مما لو جاءت في خطاب صريح.
التداخل الحكائي: من يحكي القصة؟
واحدة من أكثر التقنيات السردية إثارة في الرواية هي التداخل بين الأصوات السردية. في بعض الأحيان، لا يكون من الواضح مَن الذي يتحدث—ليلى، أمها، أم الرواية نفسها؟ هذا التداخل يجعل القارئ في حالة تأرجح بين وجهات نظر متعددة، مما يعكس الواقع المربك للشخصيات.
على سبيل المثال، في لحظات معينة، يبدو أن ليلى تتحدث عن أمها وكأنها تعيش تجربتها نفسها، وكأن حدود الذات تنهار أمام قوة الذاكرة الجماعية. هذا النوع من التداخل ليس مجرد لعبة سردية، بل هو تعبير عن كيف تتوارث النساء تجاربهن، حتى دون قصد.
التقنية السردية: الكتابة كوسيلة للمقاومة
اعتمدت حميدان على أسلوب سردي بسيط، لكنه محمّل بتوتر داخلي عميق. الجُمل قصيرة، سريعة، كأنها تلهث تحت وطأة المشاعر المكبوتة. في بعض الأحيان، يبدو السرد وكأنه يُلقى على القارئ دفعة واحدة، دون تمهيد أو تقديم تدريجي للشخصيات. هذه التقنية ليست مجرد اختيار جمالي، بل هي انعكاس لحالة الطوارئ النفسية التي تعيشها البطلة.
كذلك، فإن تكرار بعض العبارات—مثل الحديث عن الخوف، أو عن المدينة التي لم تعد كما كانت—يعزز الإحساس بالحصار النفسي. هذه التكرارات تجعل الرواية أقرب إلى نص شعري طويل، حيث تتكرر الثيمات كأنها لازمة موسيقية، تعكس دوامة المشاعر التي تعيشها الشخصيات.
الحرية، الحب، الاستقلال: أوهام مؤجلة
تكشف الرواية عن وهم الحرية، وهم الحب، وهم الاستقلال. كل ما في الحياة يبدو وكأنه مجرد وعد مؤجل، حلمٌ يُحاصر بالواقع. الشخصيات تطارد السراب: البطلة تحلم بالسفر، بالتعليم، بالحب، لكن الواقع يصطدم بها بعنف، ليعيدها إلى نقطة البداية. حتى النهايات التي تبدو مفتوحة، هي في حقيقتها إغلاقٌ آخر لدائرة الوهم.
حتى الشخصيات تحمل داخلها هذا التناقض بين الحلم والخيبة. بعض القراء رأوا في "شهيرة" شخصية قوية ومؤثرة، لكن بالنسبة لي، كانت معاناة ياسمين وابنتها ليلى أكثر وقعًا، ربما لأن ليلى لم تكن مجرد ضحية للواقع، بل كانت تمثل جيلًا كاملًا يُحرم من أحلامه باسم التقاليد أو السلطة أو الحرب. مقارنة بأمل في ميثاق النساء، تبدو ليلى أكثر هشاشة، وأكثر غرقًا في آلامها، وكأنها امتداد لكل نساء الرواية اللواتي لم يجدن ملاذًا آمنًا، لا في الحب، ولا في الوطن، ولا حتى في أنفسهن.
الرواية، في جوهرها، ليست فقط عن النساء في مواجهة مجتمع ذكوري، بل عن الإنسان في مواجهة الأوهام التي صُنع بها تاريخه. فحين حلمت الشخصيات بالسلام، جاءت الحرب؛ وحين سعت ليلى نحو مستقبل مختلف، وجدت نفسها تعيد أخطاء من سبقوها.
بين ميثاق النساء وأغنيات للعتمة: مقارنة غير مقصودة
لم تكن المقارنة بين أغنيات للعتمة وميثاق النساء في الحسبان، لكن تشابه الموضوعات فرض نفسه أثناء القراءة. قضايا الزواج المبكر، السلطة الذكورية، الألم، والكتابة كخلاص وحيد، تتكرر في الروايتين، وإن بأساليب مختلفة.
في ميثاق النساء، تجسّد "أمل" شخصية تناضل لتحقيق أحلامها رغم العراقيل، بينما تبدو "ليلى" في أغنيات للعتمة أكثر استسلامًا للألم، وكأنها لا تمتلك حتى رفاهية الحلم. هذه المفارقة تضع الشخصيتين على طرفي نقيض: إحداهما تقاوم، والأخرى تغرق في معاناتها بصمت.
ما يميز أغنيات للعتمة هو قدرتها على رسم شخصيات نسائية متباينة في تفاصيل حياتها، لكنها متشابهة في مصائرها. مقارنة "ليلى" بأمها، أو بشهيرة، تكشف أن الفوارق بين الأجيال ليست جوهرية، إذ تظل البنية الاجتماعية تعيد إنتاج القهر ذاته، وإن تبدّلت مظاهره.
وعند النظر إلى الروايتين في سياق أوسع، نجد أن فكرة الهروب والبحث عن الذات حاضرة في كلتيهما، لكن بينما في ميثاق النساء يظهر الأمل كإمكانية واقعية، يبدو في أغنيات للعتمة أكثر هشاشة، والمقاومة فيها أشبه بصراع منهك مع العتمة التي لا تفتأ تبتلع الضوء.
الخاتمة: لماذا تبقى الرواية معنا؟
في نهاية القراءة، أجد نفسي أمام سؤال يتكرر: كيف يستطيع الأدب أن يكون بهذا الصدق، بهذا الألم، وبهذا الجمال في الوقت ذاته؟ أغنيات للعتمة ليست مجرد رواية عن الحرب أو النسوية أو القهر الاجتماعي، بل هي نص أدبي يشتبك مع الشعر، مع الفلسفة، مع السياسة، ليخلق تجربة قراءة ممتدة، لا تنتهي بإغلاق الكتاب.
فقدان الذاكرة، كما تشير إليه الرواية، هو شكل من أشكال السفر، والنسيان قد يكون رحلة أخرى نحو اكتشاف الذات. لكن مع هذه الرواية، لا يمكن النسيان بسهولة.
ليست كل الروايات تُنسى بعد قراءتها، وبعضها يظل يلاحق القارئ بأسئلته ومصائره المفتوحة. أغنيات للعتمة واحدة من تلك الروايات، لأنها لا تروي حكاية بسيطة، بل تُشرك القارئ في معركة نفسية وفكرية، تجعله يتساءل: هل نملك حقًا حرية تقرير مصائرنا، أم أننا مجرد استمرارية لما كان قبلنا؟
-
Sara Rashad
أغنيات للعتمة ـ أيمان حميدان
الرواية كملخص للألم عند النساء
يُعَدّ عنوانُ الروايةِ غالبًا العتبةَ الأولى التي يدخل منها القارئ لعوالم الرواية. لكن عنوان الرواية "أغنيات للعتمة" يعطي انطباعًا أوليًا باحتمالية الدورالمحوري الذي قد يلعبه الغناء في أحداثها، وربما عن قدرته على التأثير سلبًا أو إيجابًا في مسارها. يبدو الغناء هنا في العنوان رمزًا للضوء والحياة، تلك التي تفتقدها الشخصيات النسائية الرئيسية. غيابه، لا سيما في صوت شهيرة، يعكس انكسارها، وليس إلا استعارةً لتراجع قدرة النساء على تغيير مصائرهن في عالم تحكمه قوانين الرجال وصراعاتهم. يمثل الغناء، أو بالأحرى فقدانه، مفتاحًا لفهم المسار المأساوي لحياة النساء في الرواية، حيث تتقاطع حكاياتهن عبر أجيال مختلفة تمتد على مدار أكثر من ثمانين عامًا. من خلال هذا الرمز، تضع الكاتبة إيمان حميدان النساء في مواجهة قهر اجتماعي ونظام ذكوري يحدد مصائرهن، مما يجعل الغناء غائبًا حاضرًا في خلفية الأحداث وخيالها، وكأنه شاهد كان بالإمكان توظيفه دراميا بشكل أكبر.
تبدأ الرواية بشهيرة ذات الأربعة عشر عاما في 1908 وأمها تفركها بالماء والصابون لتحضيرها لزواج مرتب لتكون بديلا لأختها المتوفاة التي ذهبت بعد أن تركت طفلين خلفها يحتاجان سريعا لأم. شهيرة، التي ما زالت طفلة بنفسها، كانت ترى العالم عبر الغناء، الذي يشكّل جزءًا من هويتها وتصورها للحياة. أغنيات للعتمة تبدأ بحكاية شهيرة في البقاع وغربتها الطويلة بعد زواجها. تنتهي الرواية عند أسمهان، ابنة ليلى حفيدة شهيرة، التي تهرب إلى أميركا بعد اختطاف زوجها لابنها، وسط تداعيات الحرب الأهلية اللبنانية. تروي أسمهان الأحداث على شكل رسالة طويلة موجهة إلى صديقتها، وكأنها توثّق بها إرثًا من الألم والمعاناة. هذه الرسالة تمثل خيطًا يربط الحكايات المتشابكة لكل من شهيرة، وابنتها ياسمين، وحفيدتها ليلى، لتتلاقى القصص في تصوير متكرر لمآسي النساء اللبنانيات عبر الزمن. الزمن الذي يصعد لكنّ مصائر النساء فيه تتشابه.
تبدأ حكاية شهيرة منفصلة عن حكايات أمها وكأنها تبدأ من العدم لتشكَل بذرة الرواية السائرة بشكل خطي حيث يبدأ السرد على لسان أسمهان بين 1908 و 1982. تسير حكايات ياسمين ابنة شهيرة ووليلى الحفيدة لتمثل كل حكاية تكرارًا لعشرات الحكايات التي مرت علينا جميعا لنساء نعرفهن أو عشنا معهن أو ربما تشابهت حكاياتهن مع حكايتنا الشخصية. ففي أغنيات للعتمة تبدو كل النساء ضحايا. سواء كن شخصيات رئيسية أو ثانوية كمنى ابنة فايز أو ويدا الصديقة التي يجب أن تصلها الرسالة. كل واحدة منهن لم يكن لها حق الاختيار أو تحديد ملامح حياتها. تختلف المصائر و تتشابه النهايات كمأساة لكن السبب دائما هو الرجل.
تنحاز الرواية بوضوح إلى النساء الضحايا في مواجهة عالم يكون للرجل فيه أشكال متعددة تنحصر معالم هذه الأشكال في الانهزامية, الضعف, الانتهازية وأخيرًا بالعنف، وربما القتل. في البدء كان الجد الأكبر نايف الدالي كمثال للرجل الجاهل العنيد, الذي كان سلاح شهيرة الوحيد ضده الكذب والصمت لتبني حياة متمناه لأولادها ولتضمن لهم تعليما حُرِمتْ هي منه. ثم النموذج المنهزم لزوج ابنتها ياسمين. أما أستاذ الفيزياء يوسف فعليه أن يعطي الصورة النمطية لليساري العربي الذي يصطاد نساءه بالشعارات ويهرب عند التحدي الأول. حتى شخصيات ابناء البطلة الأولى للرواية, أو أبناء شهيرة, استسلمت شخصياتهم لهذه الصورة النمطية السهلة عن الرجل العربي, ففايز الذي بدأت شخصيته بالرواية بشكل إيجابي كفتى صغير بجانب خالته/ أمه البديلة كان على شخصيته أن تتطور ضمن الرؤية المسيطرة في الرواية كسبب من أسباب مأساة ليلى ابنة أخته.
في الجهة الأخرى وحيث الضحايا النساء, تبدو الأجيال النسائية الأربعة مستسلمة, خاضعة جزئيا وغير قادرة على الفعل بشكل حقيقي. فأما محاولات غير ثورية أو عميقة التأثير كمحاولات كشهيرة أو حتى غير راغبة فيه كحفيدتها ليلى. أسمهان وهي صوت الرواية وساردة الحكايا تبدو أيضا ضعيفة رغم صعود الزمن وانحسار السطوة الذكورية. وكأن مأساتها تؤكد أن حرية الاختيار سواء في الدراسة, العمل, أو اختيار شريك الحياة غير كافية في مجتمعات يحكمها الرجال ويضعون قوانينها. لا فائدة من أي محاولات والخلاص الوحيد هو الهروب.
تقوم الرواية على ثنائية الخير والشر, الخير امرأة والشر بالضرورة رجل. كأن هذه الثنائية منفصلة عن أي تأثير خارجي حولها من تأثير التقلبات السياسية, المجتمع أو حتى التأثير المهم للدين. حاولت الرواية في سيرها الخطي الزمني ذكر التغييرات الحاصلة في المنطقة كالحرب العالمية الأولى ومجاعة لبنان الكبرى والحرب العالمية الثانية والتغييرات السياسية في لبنان ووصولا للحرب الأهلية لكن كل هذه الأحداث لا تقدم جديدًا للقارئ غالبا ما ينتظر من أي رواية أبعد من السرد وأعمق من نقل التاريخ كما هو. كان يمكن للرواية أن تعطي للتاريخ أبعادا أخرى بتحليل أو أن تكشف جوانبا قد يكون القارئ غير اللبناني يجهلها وتثير فضوله للبحث والتقصي. كمثال على هذا الإخفاق هو الأشارات المتكررة لجماعة داهش والداهشية وانضمام بعض من أفراد العائلة للحركة والتي كانت فرصة للرواية لأن تخلق عالما مورازيا للنساء بطقوسه وربما خلق مؤثرات إضافية في مصاْئرهن غير الرجال.
تبدو الرواية مخلصة للتصور الاستشراقي للرجل العربي بالصور النمطية التي تُصور الرجل العربي غالبًا كشخص مُتسلط، يعتمد في علاقاته الاجتماعية والعائلية على القهر والاستبداد. الرجل الذي يُمارس سلطته بدون أي مساءلة، وكأنها امتداد لطبيعة بيئته السياسية التي حضرت كما أسلفت سابقا بشكل هامشي.
صدرت الرواية عن دار الساقي في بيروت وهي الرواية الخامسة للبنانية الروائية والباحثة ايمان حميدان. ايمان الحائزة على جائزة كتارا 2015 عن رواية خمسون عاما من الجنة والتي تقوم بتعليم الكتابة الابداعية تركز في كتاباتها على الذاكرة وصوت النساء وهذا كان واضحا في رواية أغنيات للعتمة.
الرواية تبدو مألوفة للقارئ العربي, هذا الألم النسائي نعرفه. هي تدوين غير جديد لحكايات النساء ومعاناتهن في ظل مجتمع ذكوري قاسٍ وكأن القارئ، عندما ينتهي من الرواية، عليه أن يسأل نفسه: ماذا قدمت لي هذه الرواية؟ وإلى متى ستظل صورة النساء العربيات عالقة في دائرة المأساة روائيًا؟ وهل هذه الصورة النمطية هي جواز مرور للجوائز والترجمة للغات أخرى؟ مجرد تساؤلات رافقتني بعد الانتهاء من الرواية. صاحبتُ الألم أثناء القراءة وكنت أعرفه مع النساء الأربعة لكنني كنت أنتظر ما هو أكثر من الألم في رواية صعدت للقائمة الطويلة لجائزة البوكر العربية.
-
ماجد رمضان
- يحتار القارئ في تصنيف هذه الراوية، أهي اجتماعيّة، طبقًا لعرضها الواقع الاجتماعي، وقصص النّساء، الحبّ، الخيبات، والتعنيف الأسري…الخ؟ أم هي رواية سياسيّة، نظرًا لعرضها أحوال لبنان سياسيًّا على امتداد عقود؟ أم هي رواية تاريخيّة، استنادًا إلى الأحداث التّاريخيّة الواردة في متن الرّواية التي تنعكس سلبًا أو إيجابًا على أحوال أبطالها؟
- لكنها رواية حميمية نشعر ونحن نقرأها أنّها تخصّنا، أو تخصّ أناسا نعرفهم وعشنا معهم، مرثية مكتوبة عن مرثيات لم يُقيّض لها أن تُكتب بأيدي صاحباتها، مرثية نساء حزينات حِيْلَ بينهن وبين أحلامهن، واضطررن إلى العيش في الظل.
- عنوان الرواية:
- "أغنيات للعتمة” عنوان بسيط، لكنه “حمّال أوجهه”. ذلك أنّه للوهلة الأولى، يجهل القارئ؛ مَن هو/هي، أو هم/هنّ الذين يغنّون للعتمة أغنياتهم تلك؟ ولماذا؟ وهل تلك الأغنيات؛ مديح وثناء وتمجيد للعتمة، أم ذمٌّ وهجاء لها؟
- و هو نفسه ترجمة للإحساس بالرثاء، فكيف يمكن أن يغنّي المرء للعتمة؟ فبطلات الرواية يغنين في العتمة، يغنين رغم العتمة ويغنين للهرب من العتمة.
- يغنين للعتمة التي عاشت فيها أربعة أجيال من نساء عائلة واحدة. الجدة شهيرة، وابنتها ياسمين والحفيدة ليلى، ثم أسمهان ابنة الحفيدة التي ستروي الحكاية كلها، حكاية عائلتها، وخصوصا نساءها.
"فهذه شهيرة الجدة كانت تغنّي كلّما ثقل قلبها وشعرت بالحزن. تريد البكاء، إلاّ أنّ الدمعة لم تعرف يوماً طريقاً إلى عينيها. تبكي روحها ولا يمسح دموع الروح سوى الغناء. يساعدها الغناء على حياة لم تتوقعها.
- والعتمة لغة هي ثلث الليل الأول بعد غيبوبة الشفق، أو صلاة العشاء، أو «صلاة العتمة» كما كان يسميها الأعراب؛ الأمر الذي يسوغ الرأي في أن الأغاني التي تخيرتها الكاتبة، هي الإضاءة أو النور الذي يضيء هذه العتمة.
- ولا تكتفي الرواية بسرد قصص نساء العائلة، بل هي تسرد التاريخ والوطن والمجتمع عبر قصص نسائها. فتجد تداخل بين تفاصيل تاريخ العائلة وتاريخ الوطن وتاريخ العلاقات الاجتماعيّة وتاريخ السلطة. فيجد القارئ نفسه في هذه الرواية أمام قصص حروب ونزاعات متسلسلة متعاقبة، فالحرب العالميّة الأولى موجودة، والثانية كذلك، وحرب استقلال لبنان، ونكبة فلسطين، والثورات الحديثة والحرب اللبنانيّة التي اشتعلت سنة 1975.
- كتبت الرواية بأسلوب سردي يمكن أن نسميه بـ”السّرد الممغنط” الذي يشدُّ القارئ من حيث يدري، ولا يدري.فظهر السّردُ جميلاً متدفّقًا، خاليًا مما يبعث على الملل.
- تحضر في الرواية أغاني الندب، أغاني الأفراح والأتراح، أغاني الحصاد، أغاني الاستقلال، أغاني التعبير الوجداني، وأغاني العشق والحب. كما يحضر فنانون/ات من نجوم الغناء العربي في تلك الفترة: أم كلثوم، أسمهان، وغيرها. وقد رافق الغناء الزمن السردي للرواية
ولم تكن الكتابة اول من يستخدم الأغنية في السرد فهناك أكثر من رواية ألهمت الأغنية، وأكثر من أغنية ألهمت الرواية مصادر ومراجع؛ ولعل أشهرها الجزء الأول من رواية مارسيل بروست «في البحث عن الزمن المفقود» و«صحراء التتر» للإيطالي دينو بوزاتي
- توسع الكاتبة نصها لأصوات من أجيال مختلفة، إذ تشابكت على خطه الزمني ثيمات متعددة بدءا من الهجرة مرورا بالحب وصولا إلى الموت وتشبيح الأفكار وضمور الأحلام.
- خلقت الكاتبة مزيجا بين سرد الحكاية وبين الأسلوب واستخدمت عدة تنويعات وتقنيات وأدوات فنية مثل الرسائل واليوميات الحوارات أو حكايات الرواية أسمهان أو الأغاني، والانتقال بين صيغ مختلفة للسرد وتنوع الضمائر بين غائب ومخاطب ومتكلم مما ساعد في خلق جوا غنيا في ابراز الشخصيات وفي تطور وبناء السرد الروائي،.
- وأتت اللّغة سلسة، سهلة الهضم والفهم، معاصرة، بعيدة عن فذلكات التفاصح المبالغ فيه، ومحاولات الاستعراض،
-
والبصمة الفارقة لهذا النص تتمثل في المغامرة بالحركة بين حلقات زمنية متباعدة والإحالة إلى شخصيات وأحداث لها مرجعيات واقعية وتاريخية دون أن يؤدي ذلك إلى ترنح الرواية بالحشو.
| السابق | 1 | التالي |