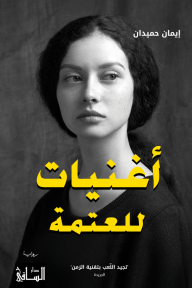"أغنيات للعتمة" ل (إيمان حميدان): بين الألم والسرد والتمرد
نجيب التركي
مدخل: ألم مستعاد، غواية متجددة
عند الانتهاء من قراءة رواية ما، قد تتلاشى بعض النصوص سريعًا، بينما تظل أخرى محفورة في الذاكرة، كوشمٍ لا يُمحى. وهذا ما حدث معي بعد أغنيات للعتمة لإيمان حميدان (دار الساقي، الطبعة الأولى 2024). تمامًا كما بقي الألم الذي سبّبته لي ميثاق النساء لحنين الصايغ، وجدتني، وكأنني تحت تأثير غواية خفية، أُسلم نفسي إلى ألمٍ آخر، مختلف في طابعه لكنه لا يقل عمقًا. لم تكن مجرد قراءة، بل تجربة غمرتني، أخذتني إلى فضاء زمني متشظٍّ، حيث يتداخل السرد بالحقيقة، ويعانق الماضي الحاضر، بينما تتكرر المصائر، كأنها تعيش تحت سلطة قَدَر غير مرئي.
العنوان والغلاف: دلالات أولية
العنوان وحده يكثّف المفارقة المركزية للرواية، حيث يحمل العنوان طابعًا شعريًا يثير التأمل: "أغنيات" توحي بالحياة والبوح، لكنها تأتي "للعتمة"، وكأننا أمام فعل غنائي مقاوِم، صوت يحاول اختراق السكون والظلام.
الغلاف، يتسم بتصميمه البسيط القوي، فهو يحمل دلالات بصرية وعاطفية متشابهة تتماشى مع أجواء الرواية. حيث يأتي بالأبيض والأسود، إذ ترينا صورة جانبية لامرأة نصف وجهها في النور،والنصف الآخر في الظل، ذات نظرة شاردة، في انعكاس بصري لحالة الانشطار التي تعيشها شخصيات الرواية بالتأمل وربما بالحزن الدفين. وهذا يعكس الصراع الأزلي بين النور والظلام، بينما تبرز الكتابة الصفراء كعنصر دلالي يوحي بمحاولة اختراق العتمة، وربما بإنذارٍ خفيّ يلوح في الأفق.
صدمة البداية: السرد كمرآة للاضطراب
بعد تجاوز الإهداء والاقتباس، وجدت نفسي في مواجهة الصفحة الأولى من الرواية، حيث فرضت السوداوية حضورها الطاغي، منذ اللحظة الأولى. لا فسحة للأمل هنا، بل اختناق نفسي يسري مع كل جملة. البداية صادمة ومشحونة بالتوتر، حيث يبدو الرحيل هو الحدث الأول، لكنه ليس مجرد انتقال جغرافي، بل هروب اضطراري، أشبه بفعل نجاة من واقع يضيق على البطلة ويخنقها.
الخوف ليس مجرد إحساس في هذه الصفحة، بل يكاد يكون شخصية خفية تلاحق البطلة وتدفعها لاتخاذ قراراتها. تكراره المكثف يعكس اضطرابها العميق، بل ويؤسس لأحد محاور الرواية الرئيسية: العجز أمام الظلم، حتى حين تمتلك أدوات الدفاع عن النفس. تشعر البطلة بأن العائلة، القانون، والمعرفة كلها لم تحمها، وكأنها تُركت وحيدة في مواجهة قسوة العالم.
"بت أشعر بالغربة والحنين معًا وأنا في بيروت"—هذه الجملة أيقظت في ذهني صدى أبيات البردوني:
"كأنني خارج التاريخ منفردٌ
كأنني آخر الأحياء في وطني"
ليست الغربة هنا مجرد ابتعاد جغرافي، بل حالة من الانفصال الداخلي عن المكان، عن الوطن الذي لم يعد كما كان. البردوني، في قصيدته عن صنعاء، عبّر عن هذا الشعور ذاته:
"صنعاءُ ماذا؟ لستِ صنعاءَ التي
كانَتْ تُسمى في الظلامِ منارا"
وكأن الرواية والشعر يتقاطعان هنا، حيث يتحول الوطن إلى فضاء للخسارات المتكررة، تمامًا كما تقول البطلة:
"بات الشعور بالخسارة العمود الفقري لحياتي. الخسارة كل لحظة: أمام طريق يحتلها رجال الميليشيات، أمام طفل وحيد، قطة جائعة، بيت دمره القصف، شارع مظلم، نشرة أخبار قاتلة، جثث تعرضها الشاشات بلا قلب...."
التقنيات السردية: اضطراب الزمن والمشاعر
تعتمد الرواية على أسلوب سردي يتجاوز التقاليد الكلاسيكية، حيث تُلقى الأسماء والعلاقات دفعة واحدة دون مقدمات، في انعكاس واضح للفوضى الداخلية التي تعيشها البطلة.
يمكن قراءة هذا الأسلوب من منظورين:
1. إيقاع مضطرب يعكس الحالة النفسية: البطلة تتحدث وكأنها تسابق الزمن، تُسقط الأسماء والعلاقات دون ترتيب، كما لو أنها تكتب من داخل عاصفة مشاعرها الخاصة.
2. كسر التقاليد السردية: بدلاً من تقديم الشخصيات تدريجيًا، تُقحم الرواية القارئ مباشرة في قلب المشهد، وكأنها تجبره على مشاركة هذه الفوضى الشعورية. هذا الأسلوب قد يكون مربكًا في البداية، لكنه جزء من تجربة الرواية، حيث تكتشف الشخصيات والعلاقات تدريجيًا، كما تكتشف البطلة ذاتها.
الفضاء الزمني: بين الذاكرة والتكرار
الرواية تتلاعب بالزمن بطريقة تجعل القارئ غير قادر على وضع تسلسل زمني دقيق للأحداث. هناك انتقالات مستمرة بين الماضي والحاضر، دون أن يكون أحدهما هو المسيطر على الآخر. كأن الزمن في أغنيات للعتمة ليس خطيًا، بل هو أقرب إلى ذاكرة مفتوحة تتدفق بحرية، مما يعكس حالة الشتات التي تعيشها الشخصيات.
هذا التداخل الزمني يعزز الإحساس بأن الشخصيات عالقة داخل حلقة من التكرار، حيث تعيش النساء المصائر ذاتها، ولو بأشكال مختلفة. فليلى، بطلة الرواية، تبدو وكأنها امتداد لأمها وجدتها، تعيش ما عاشته النساء قبلها، وتواجه القيود نفسها، وكأن الزمن لم يتحرك إلا في شكله الظاهري.
مسألة التقمّص: أين تبدأ الذات وأين تنتهي؟
إحدى أكثر الأفكار إثارة في الرواية هي مسألة "التقمّص"، ليس بالمعنى الصوفي، بل في المعنى النفسي والاجتماعي. الشخصيات تعيش حيوات غيرها داخل نفسها، سواء بوعي أو بدونه. ليلى تحمل داخلها صوت أمها وتجاربها، تمامًا كما تشعر ياسمين (الأم) بأنها عالقة في إرث النساء السابقات.
هذا التقمّص لا يتوقف عند الشخصيات، بل يمتد إلى النص نفسه. فنحن، كقرّاء، نجد أنفسنا أحيانًا غير متأكدين: هل تتحدث ليلى عن نفسها أم عن أمها؟ هل هذا الحدث وقع فعلًا أم أنه إعادة سرد لحكاية سابقة؟ هذا التداخل بين الشخصيات يجعل الحدود بين الذات والآخر غير واضحة، كأن الشخصيات تتبادل الأدوار دون وعي منها.
الإسقاطات: بين الأدب والواقع السياسي
الرواية تحمل مستويات متعددة من الإسقاط، تتجاوز الحكاية الفردية إلى أبعاد سياسية واجتماعية أوسع. بيروت ليست مجرد مكان تجري فيه الأحداث، بل هي كيان متحول، يعيش داخل الشخصية بقدر ما تعيش هي داخله. بيروت هنا هي مدينة الحرب والانقسامات، لكنها أيضًا مدينة الأحلام المجهضة.
هذه المدينة التي بدت "أوسع عالم يمكن للإنسان أن يعيش فيه"، هي ذاتها التي تحولت إلى سجنٍ كبير بفعل الحرب والخوف.
التتابع الرمزي والاستطراد الحكائي
تعتمد الرواية على تقنية "التتابع الرمزي"، حيث تتراكم العناصر الصغيرة—طفل يتيم، قطة جائعة، شارع مظلم—لتشكل في النهاية صورة أكبر، صورة عالم مشبع بالخسارات. وهذه إحدى أبرز تقنيات الرواية، كما أن الاستطراد الحكائي تتوالى فيه الأحداث ليس فقط بناءً على التسلسل الزمني، بل وفقًا لروابط رمزية وإيحائية تجعل من كل حدثٍ امتدادًا لما قبله. هذا الأسلوب يجعل الرواية تبتعد عن السرد التقليدي، كما أن هذه التقنية تعمّق الأثر النفسي على القارئ، إذ لا تُطرح القضايا مباشرة، بل تتسلل عبر المشاهد اليومية، فتترك أثرًا أقوى مما لو جاءت في خطاب صريح.
التداخل الحكائي: من يحكي القصة؟
واحدة من أكثر التقنيات السردية إثارة في الرواية هي التداخل بين الأصوات السردية. في بعض الأحيان، لا يكون من الواضح مَن الذي يتحدث—ليلى، أمها، أم الرواية نفسها؟ هذا التداخل يجعل القارئ في حالة تأرجح بين وجهات نظر متعددة، مما يعكس الواقع المربك للشخصيات.
على سبيل المثال، في لحظات معينة، يبدو أن ليلى تتحدث عن أمها وكأنها تعيش تجربتها نفسها، وكأن حدود الذات تنهار أمام قوة الذاكرة الجماعية. هذا النوع من التداخل ليس مجرد لعبة سردية، بل هو تعبير عن كيف تتوارث النساء تجاربهن، حتى دون قصد.
التقنية السردية: الكتابة كوسيلة للمقاومة
اعتمدت حميدان على أسلوب سردي بسيط، لكنه محمّل بتوتر داخلي عميق. الجُمل قصيرة، سريعة، كأنها تلهث تحت وطأة المشاعر المكبوتة. في بعض الأحيان، يبدو السرد وكأنه يُلقى على القارئ دفعة واحدة، دون تمهيد أو تقديم تدريجي للشخصيات. هذه التقنية ليست مجرد اختيار جمالي، بل هي انعكاس لحالة الطوارئ النفسية التي تعيشها البطلة.
كذلك، فإن تكرار بعض العبارات—مثل الحديث عن الخوف، أو عن المدينة التي لم تعد كما كانت—يعزز الإحساس بالحصار النفسي. هذه التكرارات تجعل الرواية أقرب إلى نص شعري طويل، حيث تتكرر الثيمات كأنها لازمة موسيقية، تعكس دوامة المشاعر التي تعيشها الشخصيات.
الحرية، الحب، الاستقلال: أوهام مؤجلة
تكشف الرواية عن وهم الحرية، وهم الحب، وهم الاستقلال. كل ما في الحياة يبدو وكأنه مجرد وعد مؤجل، حلمٌ يُحاصر بالواقع. الشخصيات تطارد السراب: البطلة تحلم بالسفر، بالتعليم، بالحب، لكن الواقع يصطدم بها بعنف، ليعيدها إلى نقطة البداية. حتى النهايات التي تبدو مفتوحة، هي في حقيقتها إغلاقٌ آخر لدائرة الوهم.
حتى الشخصيات تحمل داخلها هذا التناقض بين الحلم والخيبة. بعض القراء رأوا في "شهيرة" شخصية قوية ومؤثرة، لكن بالنسبة لي، كانت معاناة ياسمين وابنتها ليلى أكثر وقعًا، ربما لأن ليلى لم تكن مجرد ضحية للواقع، بل كانت تمثل جيلًا كاملًا يُحرم من أحلامه باسم التقاليد أو السلطة أو الحرب. مقارنة بأمل في ميثاق النساء، تبدو ليلى أكثر هشاشة، وأكثر غرقًا في آلامها، وكأنها امتداد لكل نساء الرواية اللواتي لم يجدن ملاذًا آمنًا، لا في الحب، ولا في الوطن، ولا حتى في أنفسهن.
الرواية، في جوهرها، ليست فقط عن النساء في مواجهة مجتمع ذكوري، بل عن الإنسان في مواجهة الأوهام التي صُنع بها تاريخه. فحين حلمت الشخصيات بالسلام، جاءت الحرب؛ وحين سعت ليلى نحو مستقبل مختلف، وجدت نفسها تعيد أخطاء من سبقوها.
بين ميثاق النساء وأغنيات للعتمة: مقارنة غير مقصودة
لم تكن المقارنة بين أغنيات للعتمة وميثاق النساء في الحسبان، لكن تشابه الموضوعات فرض نفسه أثناء القراءة. قضايا الزواج المبكر، السلطة الذكورية، الألم، والكتابة كخلاص وحيد، تتكرر في الروايتين، وإن بأساليب مختلفة.
في ميثاق النساء، تجسّد "أمل" شخصية تناضل لتحقيق أحلامها رغم العراقيل، بينما تبدو "ليلى" في أغنيات للعتمة أكثر استسلامًا للألم، وكأنها لا تمتلك حتى رفاهية الحلم. هذه المفارقة تضع الشخصيتين على طرفي نقيض: إحداهما تقاوم، والأخرى تغرق في معاناتها بصمت.
ما يميز أغنيات للعتمة هو قدرتها على رسم شخصيات نسائية متباينة في تفاصيل حياتها، لكنها متشابهة في مصائرها. مقارنة "ليلى" بأمها، أو بشهيرة، تكشف أن الفوارق بين الأجيال ليست جوهرية، إذ تظل البنية الاجتماعية تعيد إنتاج القهر ذاته، وإن تبدّلت مظاهره.
وعند النظر إلى الروايتين في سياق أوسع، نجد أن فكرة الهروب والبحث عن الذات حاضرة في كلتيهما، لكن بينما في ميثاق النساء يظهر الأمل كإمكانية واقعية، يبدو في أغنيات للعتمة أكثر هشاشة، والمقاومة فيها أشبه بصراع منهك مع العتمة التي لا تفتأ تبتلع الضوء.
الخاتمة: لماذا تبقى الرواية معنا؟
في نهاية القراءة، أجد نفسي أمام سؤال يتكرر: كيف يستطيع الأدب أن يكون بهذا الصدق، بهذا الألم، وبهذا الجمال في الوقت ذاته؟ أغنيات للعتمة ليست مجرد رواية عن الحرب أو النسوية أو القهر الاجتماعي، بل هي نص أدبي يشتبك مع الشعر، مع الفلسفة، مع السياسة، ليخلق تجربة قراءة ممتدة، لا تنتهي بإغلاق الكتاب.
فقدان الذاكرة، كما تشير إليه الرواية، هو شكل من أشكال السفر، والنسيان قد يكون رحلة أخرى نحو اكتشاف الذات. لكن مع هذه الرواية، لا يمكن النسيان بسهولة.
ليست كل الروايات تُنسى بعد قراءتها، وبعضها يظل يلاحق القارئ بأسئلته ومصائره المفتوحة. أغنيات للعتمة واحدة من تلك الروايات، لأنها لا تروي حكاية بسيطة، بل تُشرك القارئ في معركة نفسية وفكرية، تجعله يتساءل: هل نملك حقًا حرية تقرير مصائرنا، أم أننا مجرد استمرارية لما كان قبلنا؟