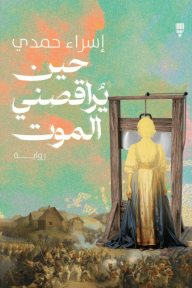قد يشعر البعض بالدهشة أو تنتابه الحيرة حين أقول إن أقوى ما يميز هذا العمل هو ذاته أكبر ما يؤخذ عليه من وجهة نظري، ألا وهو اللغة.
من حظ الكاتبة—لا أعرف إن كان حظًا جيدًا أم سيئًا—أنني ما زلت متأثرًا بآراء وأفكار الكاتب والصحافي عارف حجاوي حول اللغة وضرورة تجديد استخدامها، تعابيرها ومفرداتها، لتصبح أكثر مواكبة للعصر الذي نعيشه، والخروج من أنماط الكتابة التقليدية أو الاستخدام الجامد لمفردات عفا عليها الزمن، حتى مع تحري الكاتب للفصحى في كتابته. لذلك، جاءت مقدمة هذه المراجعة متأثرة بوجهة نظر حجاوي عن اللغة.
تدور أحداث الرواية القصيرة حين يراقصني الموت للكاتبة إسراء حمدي في العام الذي يسبق الثورة الفرنسية الكبرى، ثم تعود بالزمن عشرين عامًا إلى الوراء، في منتصف الأحداث، لتوضيح بعض الوقائع التي كان لها تأثير كبير في مجريات الأمور في الزمن الأساسي للقصة.
من خلال حياة أبطال القصة—ماريان، ڤيكتور، الأب ليوني، العرّافة لوترمان، وغيرهم— تنقل لنا الكاتبة جانبًا من أهوال هذه الفترة من التاريخ الأوروبي، حيث برزت محاكم التفتيش بأساليبها المرعبة لحماية الدولة من كل ما كان يُعتبر مخالفًا لتعاليم الكنيسة في ذلك الوقت. هذه الأحداث قد تكون معروفة للكثيرين من قراءات أو مشاهدات وثائقية سابقة، لكن السياق الدرامي الذي تم عرضها من خلاله هو ما ميّز هذه الرواية.
الرواية، من حيث الفكرة، جيدة، لكنها—في رأيي—كانت تحتاج إلى جهد أكبر في التناول والمعالجة. فقد جاء عرض الأحداث سريعًا، يمكن وصفه بالمثل المعروف مرور الكرام على بعض المشاهد أو رسم الشخصيات، خاصة في المشاهد الختامية من الرواية.
وهنا تكمن أكبر مشكلة واجهتها أثناء القراءة، ألا وهي استخدام اللغة.
جاءت لغة العمل، سردًا وحوارًا، بالفصحى، وهو ما تسبب في العديد من المشكلات للنص. على سبيل المثال، استخدمت بعض العبارات المستهلكة في وصف بطلة القصة، ماريان:
"يبحثون بين ثناياها وانحناءات جسدها—الأشبه بلوحة فنية مكتملة الأركان—عما يرضي تخيلاتهم الجامحة..."
كذلك، في أحد الفصول، نرى شخصية جاك الرسام تلقي قصيدة من المفترض أن تحمل الطابع الفرنسي الكلاسيكي، وفقًا لزمن ومكان الرواية، لكنها جاءت—للمفاجأة—عربية الطابع بشدة، وهو ما استغربته كثيرًا.
لم تستطع الكاتبة كذلك الحفاظ على النمط اللغوي الذي حاولت اتباعه، فتارة نجد اللغة سلسة، تتدفق بسهولة وانسيابية، وتارة يحدث العكس، إذ تستخدم ألفاظًا لا أعرف تحديدًا إن كانت قد عفا عليها الزمن أم لا، لكنها، على الأقل، بدت نشازًا أو دخيلة على النص، مثل:
"رُضاب" (بمعنى: الريق)، الذي استخدمته مرتين أو أكثر تقريبًا.
"شَنَّفَ" (بمعنى: نظر نظرة كره أو اشمئزاز).
بعض الفقرات بين فصول القصة لم أجد لها فائدة كبيرة في خدمة حبكة الأحداث، وكان من الممكن الاستغناء عنها.
الجدير بالذكر أن أحد العناصر التي تستحق الإشادة —وكنت أتمنى لو تم التركيز عليه وإعطاؤه مساحة أكبر من النص— هو استخدام تيار الوعي، الذي ظهر على استحياء في بدايات الأحداث، لكنه لم يستمر للأسباب التي سبق ذكرها.
وفي المحصلة النهائية، أصبحت تجربة الكاتبة أشبه باستعراض لغوي مصغر —كان يمكن أن يخرج بشكل أفضل— لأحداث معروفة، لم تأتِ بجديد.