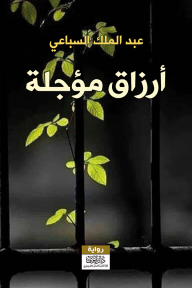عشت هذه الرواية بكل تفاصيلها،
متخيلا ًصور أشخاص الرواية، الأماكن، المدن، والشوارع، ... بكل التفاصيل.
إن كلمات مثل أرزاق.. قدر.. نصيب.. حظ.. من وجهة نظري، تتعارض، ولا تتفق، مع كلمات مثل مثابرة.. إصرار.. سعي.. شطارة.. لكني، وجدت في هذه الرواية الحل الذي بدد هذه التناقضات، خاصة، فيما يتعلق بمسألة : هل نحن مسيرون (مجبرون) أم مخيرون ؟
فرضية ١٠٠ من ١٠٠ شرحت كل شيء.
ناقشت الرواية الوضع المعيشي بالنسبة للمتعلم والذي يجد نفسه مجبرا ًعلى العمل بعيدا ًعن تخصصه، بعيدا ًعن حلمه، بعيدا ًعن وطنه حتى..
أيضـًا ناقشت العلاقة بين أرباب العمل والعامل (الموظف) الذي يبقى مجرد أجير مهما توسع أصحاب رؤوس الأموال..
ينصح الكاتب الخريجين بالقبول بأي عمل يعود عليهم بدخل جيد.. وألا ينحصر الخريج في مجال تخصصه لا سيما إذا كان هذا الأخير يعود عليه بدخل ضئيل لا يفي بالغرض..
تشجيع الخريج على الشروع بعمل حر مهما كانت شهادته رفيعة .. والتحرر من قيود الوظيفة لأنها في النهاية "عبودية"..
فالموظف يخدم رب العمل ويعمل لصالح هذا الأخير.. بينما العامل الحر يخدم نفسه، أي أنه يعمل لصالح نفسه وينمي رأس ماله. على عكس الموظف الذي كلما بدأ يغلي معلنا تمرده، تم اطفاء ثورته بقدر ضئيل من الزيادة التي لا تغني من فقر ولا تنجي من سخط زوجته ..
مشكلة التعلم ومن ثم العمل بعيدا ًعن التخصص. هذه لم تعد مشكلة. طبيعي جدا ًأن يمارس الخريج أعمال حرة ( بقال، بواب في بناية أو مزارع.. إلخ.. المهم أن يعمل.