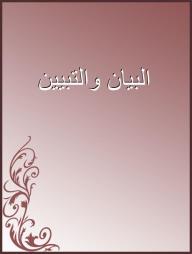كتب د.سيد محمد السيد قطب
البيان والتبيين للجاحظ من الرؤية إلى الإجراء
تأمل الأعمال البلاغية والنقدية في التراث العربي ينتج لنا نظريات جديدة في مجال الاتصال والجمال والتعبير والتفسير، استطاع الجاحظ في هذا الكتاب - الذي يعد محورا لمجموعة مؤلفاته - أن يحدد العلامة اللسانية العربية التي تولد منها الرؤى وتتفرع من شجرتها المصطلحات وتؤخذ من أوراقها عصارة الفكر البلاغي ورحيق الجمال التعبيري وعطر الاستقبال التفسيري، هذه العلامة هي مصطلح البيان، الكلمة القرآنية التي جاءت في سورة الرحمن لتصل بين التعبير والرحمة، فالبيان رحمة، لذلك يقول محمد إقبال:
قيثارتي ملئت بأنّات الجوى // لابد للمكبوت من فيضان
صعدت إلى شفتي خواطر مهجتي // ليبين عنها منطقي ولساني
بالطبع قال محمد إقبال شعره باللغة الأردية وترجم هذه المعاني شعرا الصاوي شعلان ليحدث لقاء بياني روحي نفسي بينهما.
الجاحظ اختار كلمة البيان بذكاء ورؤية، اختار الكلمة القرآنية مدخلا علميا لأبواب البلاغة وفنون النقد وعلوم الاتصال، واستطاع أن يضع تصورا شاملا للبيان فهو الكلمة والخط والإشارة والحساب ولسان الحال أو لغة الصمت، هذا الفكر محطة وصل إليها الجاحظ منتظرا النظريات السيميائية المعاصرة وهي تؤسس علم العلامات بجهد سوسير وبيرس وبارت، فكل منظومات التعبير والاتصال - التي وضع لها المجتمع أطرا وأدوات ومرجعية ودلالات - تندرج في مفهوم البيان عند الجاحظ.
استطاع الجاحظ أن يضع أسس النظرية البيانية حين أدرك مفهوم الإجراء الذي أطلق عليه التبيين، فالإنسان يبين عن نفسه بعد أن يحس ويدرك، بعد أن يرى موضوعه ويفكر فيه ويحلله ويتأمله ويصل إلى نتائج يصوغها في رسالة يفهمها الآخر الممتد في الزمان والمكان، وهذا الفكر يسبق به الجاحظ أصحاب نظرية الفينومينوجيا الذين يرون التعبير إدراك حسي وذهني وحدسي لظاهرة ما فيصب المبدع رؤيته في نص يمكن تحليله بإجراء نقدي لمعرفة كيف يرى هذا المبدع العالم.