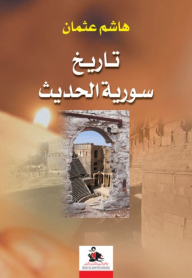يتناول هذا الكتاب تاريخ سوريا الحديث منذ نهاية الحرب العالمية الأولى، وحتى وصول حافظ الأسد لقمة هرم السلطة عام 1971.
صنف الكاتب تاريخ سوريا طبقاً للمراحل التالية:
العهد الفيصلي: 1918 – 1920
عهد الانتداب الفرنسي: 1920 – 1946
عهد الاستقلال: 1946 – 1949
الانقلاب الأول (حسني الزعيم) : مارس 1949 – أغسطس 1949
الانقلاب الثاني (سامي الحناوي) : أغسطس 1949 – ديسمبر 1949
الانقلاب الثالث (أديب الشيشكلي) : نوفمبر 1951 – فبراير 1954
مرحلة ما بعد الشيشكلي: فبراير 1954 – فبراير 1958
الوحدة مع مصر: فبراير 1958 – سبتمبر 1961
عهد الانفصال: سبتمبر 1961 – مارس 1963
عهد البعث: مارس 1963 – نوفمبر 1971
وعلى قدر ما حوى الكتاب من تفاصيل، وأحياناً تفاصيل التفاصيل، لدرجة سرد كامل التشكيل الوزاري لكل حكومة سورية على كثرتها، إلا أن تفاصيلاً أخرى كثيرة قد سقطت من الكتاب رغم أهميتها، وكنت أود أن تكون لها مساحة معتبرة، مثل تفاصيل الموقف العام قبيل هزيمة يونيو وبعدها، والصراع بين قادة الجناح القطري لحزب البعث الذي انتهى بوصول حافظ الأسد للسلطة، وهو أمرٌ عرض باقتضاب شديد.
وكان من حسن الطالع أني قبيل البدء في قراءة هذا الكتاب وفي أثنائه كنت قد شرعت في مشاهدة حلقات برنامج شاهد على العصر المرتبطة بسوريا، فشاهدت حلقات أمين الحافظ، وأحمد أبو صالح، وعبد الكريم النحلاوي، وعدنان سعد الدين، وأوصى أن تُشاهد على هذا الترتيب. والاطلاع على هذه الشهادات وعلى غيرها من المذكرات الشخصية للسياسيين خلال هذه المرحلة هام جداً لإكمال الصورة، وسأضمن في هذه المراجعة أهم ما قابلني في الكتاب وفي البرنامج.
بدأ العهد الفيصلي بإعلان فيصل ملكاً على سوريا بعد رحيل العثمانيين عن بلاد الشام على يد الإنجليز و(الثورة العربية الكبرى)، وقد عرض الكاتب إرهاصات هذه المرحلة من خلال سرد العلاقة المتوترة بين الشريف حسين والدولة العثمانية والتي انتهت بتحالفه مع الإنجليز، ثم خديعتهم له من خلال اتفاق سايكس بيكو. وفي الوقت الذي كان فيصل يسعى فيه لتوطيد أركان حكمه في سوريا وتشكيل الحكومة ومؤسسات الدولة، كانت فرنسا تطالب بنصيبها من التركة، وكان أقصى ما استطاعه فيصل هو إرسال البرقيات الاحتجاجية، أو الاحتجاج خلال مؤتمر السلام، وانحدرت المطالب إلى أن وصل الأمر لأن يطلب من الإنجليز أن يكونوا على الأقل مكان الفرنسيين! وفي النهاية خرج صفر اليدين، وفي الوقت الذي سعى فيه البعض لمقاومة القوات الفرنسية، كان قد فاوضهم سراً ووافق على شروطهم بضرورة مغادرته دمشق، ثم سوريا كلها.
سيطر الفرنسيون على دمشق بعد هزيمتهم للمقاومة في معركة ميسلون التي قاد المقاومة فيها وزير الحربية يوسف العظمة واستشهد فيها، وخلال سيطرتهم على سوريا عمدوا إلى تنفيذ سياسة ترمي إلى تحقيق غايتين: الأولى مجابهة القومية العربية التي تهدف إلى الاستقلال التام، والثانية تقوية العناصر الموالية لها تقليدياً أو التي يحتمل ولاؤها كالمسيحيين والعلويين والدروز، وكانت خير وسيلة لذلك تقطيع أوصال البلاد، ففصل منها أولاً لبنان بالشكل الذي أدى لجعله دولة مستقلة في المستقبل، وهو أمرٌ كنت أتمنى لو زاد الكتاب في تفاصيله، ثم جزأ الباقي إلى دويلات بعضها على أساس طائفي: دولة دمشق، ودولة حلب، وحكومة جبل الدروز، وحكومة العلويين، وجعل لواء إسكندرون يتمتع باستقلال إداري ومالي خاص.
وشهد هذا العهد قسوة في التعامل مع أهل البلاد وإثقال كواهلهم بالغرامات وقمع الثورات والانتفاضات بكل قسوة، وعلى الرغم من أن بدايات عهدد الاستعمار شهدت مقاومة كل الطوائف للفرنسيين، بما فيها الأقليات، فكانت ثورة الساحل بقيادة الشيخ صالح العلي (العلوي)، والثورة السورية الكبري بقيادة سلطان باشا الأطرش (الدرزي)، إلا أن أغلب من يتناول أسباب سيطرة العلويين على الجيش والسياسة طوال العقود السابقة يرجع ذلك إلى لعب الفرنسيين بورقة الأقليات، وتكثير سوادهم داخل الجيش ليكونوا ضباطه وقادته. في حين وجدت من شهاداتٍ أخرى أن ذلك يرجع لعزوف أبناء المدن والطبقات الثرية والبرجوازية عن دخول الجيش وتفضيلهم دفع البدلية، في حين وجد فيه الفقراء من أبناء الريف وأبناء الطوائف ملاذاً ووسيلة للترقي الطبقي، كما أجمعت العديد من الشهادات على دور شخصية محورية في تاريخ سوريا وهو أكرم الحوراني، الذي ما أن تأتي سيرته أمام أحد شهود العصر إلا وذكر أنه المسئول الأول عن تسييس الجيش، والحوراني من عائلة إقطاعية من حماة ولكنه كان مؤمناً بالاشتراكية، وكان يشجع الفقراء من الفلاحين من ريف حماة – ونسبة كبيرة منهم علويين – إلى الانخراط في الجيش لكي يكون له قوة داخل الجيش تجعل منه رجل سوريا الأول، وقيل فيه "إنه في كل انقلاب ومع كل انقلاب وضد كل انقلاب"!.
وكانت الحكومات المتتالية في ظل الانتداب في أوضاع مثيرة للرثاء، وأكتفي لوصفها بهذه الفقرة من الكتاب "ولم يطل الوقت حتى دبّ الخلاف بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، بسبب اتجاهات كل منهما المغايرة لاتجاهات الآخر. فالمعروف عن الشيخ تاج أنه من الموالين لفرنسا في حين أن رئيس الوزراء حسني البرازي كان من الموالين لإنكلترا. ونتيجة هذا الخلاف أنهى رئيس الجمهورية مهمة الوزارة".
وشهد عهد الانتداب أيضاً تسليم فرنسا لواء الاسكندرونة لتركيا، وفي ذلك يقول الكاتب: "ومع الأيام تكشفت الأسباب الحقيقية لضم اللواء إلى تركيا، فقد سأل صحفي فرنسي الجنرال ويغان لماذا تخلت فرنسا عن لواء الإسكندرون لتركيا؟ فأجاب: إن وجود تركيا قوية على حدود ،بلاد العرب يخفف من حماسهم ويعرقل تطورهم وتقدمهم. وعلق أحد المدرسين الفرنسيين على المعاهدة التي تخلت فيها فرنسا عن اللواء إلى تركيا بقوله: هذه المعاهدة قبر دفنا فيه حلم الإمبراطورية العربية."
وضعف وضع فرنسا في سوريا خلال الحرب العالمية الثانية، لكن بمجرد انتهاء الحرب حاولوا استعادة نفوذهم بكل صلف وعنجهية وتسببوا في العديد من المذابح، لكن الزمن كان قد تجاوزهم وانطوت صفحة الاستعمار، أو على الأقل بشكله الصريح.
تولى السوريون حكم أنفسهم بأنفسهم، وشكلوا الحكومات وأصدروا دستور دولة الاستقلال التي كان علمها هو علم الثورة السورية الأخيرة، وكان من أهم الأحداث التي شهدها هذا العهد هو فقدان فلسطين في عام 1948، وانتهى هذا العهد ببدء مرحلة الانقلابات العسكرية المتتالية في سوريا، وكانت بدايتها على يد حسني الزعيم الذي أطاح برئيس الجمهورية شكري القوتلي ورئيس الوزارة ووزير الدفاع خالد العظم.
يسرد الكتاب خلفيات الانقلاب والتي قد تبدو نتيجة لبعض الأحداث التافهة والصراعات الشخصية والاستخفاف والعنجهية، ويبدأها بحملات صحفية شنت على قيادة الجيش نتيجة لحملات تفتيش تموينية أدت للتحقيق مع بعض الموردين والضباط المتعاملين معهم، وزادت وتيرة الحملة وبدأ الضباط يشعرون بالإهانة سواء منها أو من طريقة تعامل الرئيس والوزير مع قيادة الجيش، ولابد أن الزعيم شعر بأن أيامه صارت معدودة، فقرر أن يبادر هو بالحركة.
وفي حين يرى عدنان سعد الدين أن فرنسا ليست بعيدة عن الموضوع لأن قيادات الجيش هم من الضباط الذين عملوا تحت قيادة فرنسا خلال الانتداب، إلا أننا وإن لم نر دليلاً قاطعاً، لا يمكنني أن أتجاهل هذه الفقرة التي قرأتها في الكتاب: "وارتأى حسني الزعيم أن تعلم السفارة الفرنسية بالحركة قبل ساعات من وقوعها ليضمن تأييد دولة أجنبية واحدة على الأقل، ويؤمن السلاح الكافي للجيش السوري، فحرر كتاباً أمام جميع الضباط وأطلعهم على مضمونه فوافقوا عليه، وحمله إلى السفارة الفرنسية أحد الحاضرين، عصر اليوم الذي تمَّ فيه الانقلاب".
لم يهنأ الزعيم بمقعده طويلاً، فانقلب عليه أقرب رجاله سامي الحناوي، وكان مصيره القتل بالرصاص، ثم اُنقلب على الحناوي فيما بعد، ووصل أديب الشيشكلي إلى مكانهما بعد فترة استطاع أن يثبت فيها حكمه، ليبدأ عهداً جديداً من الدكتاتورية العسكرية. وكانت كل مرحلة فيها تشهد تعديلات في الدستور، وإصدار مراسيم وقوانين جديدة، بعدها مفيدة وذات أثر، مثل المتعلقة بإنشاء دواوين المظالم، أو بأولوية استخدام اللغة العربية، وبعضها كان فقط لترسيخ مكانة الحاكم.
انتهى الحال بالشيشكلي بتمرد بعض قطاعات الجيش ضده، وآثر الرحيل في هدوء بدلاً من أن ينقسم الجيش على نفسه وهو موقفٌ يُحمد عليه، وبدأ عهد جديد من حكم المدنيين مع سيطرة لجان من العسكريين في الوقت ذاته، وكان عهداً شابه الاضطراب وعدم الاستقرار والاغتيالات السياسية – كاغتيال نائب الرئيس الأركان العقيد عدنان المالكي عام 1955 – وكذلك الصراعات السياسية وصعود الشيوعيين واندماج حزب البعث بقيادة عفلق والبيطار مع الحزب العربي الاشتراكي بقيادة الحوراني، ليصبح حزب البعث العربي الاشتراكي.
خلال هذه الفترة كان عبد الناصر يتابع أمور سوريا في هدوء من خلال إرسال بعض المبعوثين لجمع المعلومات مثل فتحي الديب، أو من خلال السفراء والملاحق العسكريين كمحمود رياض وعبد المحسن أبو النور، وبعد العدوان الثلاثي صار لعبد الناصر شعبية كاسحة بين السوريين، وفي مطلع عام 1958 وعلى إثر عدم الاستقرار السياسي والتهديدات التركية وكذلك الإسرائيلية، قرر مجموعة من الضباط السفر فوراً إلى مصر لمقابلة عبد الناصر وطلب وحدة البلدين بشكل اندماجي، ووضعوا السياسيين السوريين ورئيس الدولة شكري القوتلي أمام الأمر الواقع، فتوجه بدوره إلى مصر وطلب نفس المطلب، وتمنع عبد الناصر في البداية، ثم وافق بشروط، أهمها حل كافة الأحزاب في سوريا، ووافق السوريون ونشأت الجمهورية العربية المتحدة.
أجمعت شهادات شهود العصر على فرحة السوريين وحماستهم في بداية الوحدة، ثم فتور الحماس نتيجة ما صاحب هذه الوحدة من عيوب، وكانت أكثر الشهادات تفصيلاً في ذلك هي بطبيعة الحال شهادة عبد الكريم النحلاوي قائد الانقلاب الذي أطاح بالوحدة، والذي استفاض في عرض مظاهر تسلط الضباط المصريين، ووإزاحة السوريين من المناصب العليا حتى في جيشهم، والقبضة الأمنية لعبد الحميد السراج، والإهانات والتنكيل والتعذيب، وهي أمور يزعم السوريون أنهم لهذا العهد لم يكونوا يألفونها، لكن مجرمي البعث بعد ذلك قد سبقوا غيرهم في هذا المضمار بمراحل كما رأينا. كما ذكر النحلاوي أن السياسة المصرية في سوريا شملت نوعاً مما أسماه السلب والنهب للسلاح السوري الذي اشترته حكومات ما قبل الوحدة ونقل كميات منه إلى مصر، وأنه لو لم تنفك الوحدة لسُلب احتياطي الذهب السوري كذلك.
ويذكر النحلاوي أنه ظل لآخر لحظة يحذر المشير عامر من سوء الأوضاع والتذمر داخل الجيش والحاجة للإصلاح وإبعاد بعض القيادات المصرية، وتتقاطع مع شهادته شهادة أمين الحافظ الذي يذكر أنه صارح المشير بكل قوة بمثالب سياسات الوحدة، كما أكد أحمد أبو صالح أن اللقاء بالوزراء المصريين وبعبد الناصر لم يكن سهلاً، كما أن تطبيق السياسات الاشتراكية والتأميم على المجتمع السوري وتهديد الناس في أرزاقهم وتشديد القبضة الأمنية زاد من نفور الناس من الوحدة، وذكر بشكلٍ عارض وساخر أن المشير عامر كان قد (أعجبته القعدة في سوريا لأن الستات هناك حلوين)!.
وفي حين تذكر العديد من الكتابات ومعها الكتاب الذي بين أيدينا أن الانقلاب على الوحدة حركته قوى خارجية أغضبتها الوحدة بين البلدين من ضمنها العراق والأردن والسعودية والاتحاد السوفييتي!، بل ويذكر الكتاب أن عبد الناصر عاتب الملك سعود حين لجأ لمصر على انفاقه 2 مليون جنيه استرليني لفصل الوحدة، ليجيب عليه سعود بأنه أنفق 12 مليون وليس 2!، ويذكر كذلك أن الملك حسين في ليلة الانقلاب كان مبتهجاً وحرك بعض قواته تجاه الحدود مع سوريا ليدعم الحركة الانفصالية، إلا أن النحلاوي أكد مراراً في شهادته أن القوات التي تحركت للسيطرة على مراكز القيادة والإذاعة لم تكن تهدف إلا لتصحيح الأوضاع وتغييرها لا فصم عرى الوحدة، وأنه عندما قابل المشير أخبره بأنهم يعتبرون عبد الناصر رئيسهم والمشير قائدهم، وأن المشير كان متجاوباً مع مطالبهم في البداية وعلى هذا صدر منهم البيان رقم 9 بما يوحي بأن الأمور ستعود إلى نصابها، ثم تواصل المشير بعبد الناصر الذي أخبره بأنه سيرسل قوات لضرب الانقلابيين، وحينها سارت الأمور في وجهة الانفصال. والحقيقة أنني أميل لتبني الرأي الأخير، لأن إلقاء اللوم على المؤامرات الخارجية هو ديدن الحكام الفشلة في منطقتنا المنكوبة، في حين يتناسون دورهم المباشر في حصول الكارثة، أضف إلى ذلك أنه لو كانت النية معقودة على الانقلاب الكامل لغرض فصل الوحدة، لما صدر البيان رقم 9 الذي ذكرناه، والله أعلم.
بدأ عهد الانفصال بفك الارتباط مع مصر في كل النواحي، وكان تأييد الانفصال ملحوظاً في قطاعات متعددة سواء في الجيش أو الشعب، إلا أن المشاعر الوحدوية ظلت جياشة رغم ذلك، وحدثت صدامات بعضها مسلح وقُمعت، ومع تصاعد الحرب الإعلامية بين النظامين في مصر وسوريا، إلا أن فكرة إعادة الوحدة - ولكن على أسس مدروسة – ظلت تعاود الطرح من حين لآخر، ويذكر النحلاوي أن عبد الناصر لم يكن يقبل إلا أن تتم وفقاً لشروطه ورؤيته هو.
لم يطل عهد الانفصال بدوره فحدث انقلاب آخر عام 1963 وصل به البعث للسلطة، قام على أكتاف الضباط البعثيين والناصريين والوحدويين. ولم يخل هذا العهد من الاضطرابات والصراع على السلطة، وكان من أبرز أحداثه أحداث حماة عام 1964 حين انتفض عدد من شباب المدينة نتيجة لاستفزازات رجال البعث وشعاراتهم المسيئة للدين، وتطورت الأمور ليحدث اشتباك مسلح فتوجهت قوات الجيش لتقمع الانتفاضة بكل قسوة، وتُقصف مأذنة جامع السلطان، وتختلف التقديرات في أعداد الضحايا ولكنها يبدو أنها لم تقل عن ال70، ويذكر أحمد أبو صالح دوره في محاولات التهدئة، في حين يكرر أمين الحافظ أنه بشهادة شيوخ المدينة قد أنقذ حماة من الدمار، رغم أنه كان المسئول الأمني والعسكري الأول في هذا العهد، ويؤكد عدنان سعد الدين على ذلك بأنه عفا عن أهل المدينة. وفي هذه المرحلة حدثت محاولة انقلابية وحدوية من الضابط الناصري العقيد جاسم علوان والذي تواصل قبلها مع عبد الناصر الذي أقره على مخططه وأخبره أنه لو رأى أن مخططه قابل للنجاح بنسبة 50% فليتقدم!، وقمعت هذه المحاولة بكل قسوة، وعلى حد تعبير أمين الحافظ (خرجوا علينا بالبارودة فواجهناهم بالبارودة).
لكن كل المراحل السابقة كانت ترسخ لنظام الحكم الجديد في سوريا، فالانقلابات المتتالية قد نتج عنها تسريح أعداد كبيرة من الضباط من أصحاب الخبرة والكفاءات مع كل انقلاب، وكان الانقلاب الأخير بدوره اكمالاً لسلسة التسريحات، مع إحلال ضباط بعثيين – وبالأخص علويين – محل الضباط المستغنى عنهم، وساعد على ذلك كون المسيطرين على الجيش في ذلك الوقت على رأسهم صلاح جديد وحافظ الأسد، وكلاهما علوي. أما حزب البعث ذاته، فقد انقسم ما بين قيادة قومية وقيادة قطرية، وأطاحت القيادة القطرية بالقومية عام 1966 وانقلبت على أمين الحافظ الذي قاومهم بشجاعة إلى أن فرغت ذخيرته هو وأنصاره، فقبض عليه وأودع السجن. وفي شهادة أحمد أبو صالح تحدث عن محاولته تدبير انقلاب لكنه انكشف وقُبض عليه وعُذب في السجن تعذيباً شديداً.
لم يستفض الكتاب في الحديث عن هذه الفترة رغم الحدث المزلزل لهزيمة يونيو 67 والذي اكتفى بالتعبير عنه بقوله: "لكن الهزة الكبرى التي عرفها عهد الأتاسي، هي نكسة الخامس من حزيران/ يونيو ١٩٦٧، التي أدت إلى تشتت الجيش السوري وفقدان سورية أجزاء كثيرة من أراضيها في منطقة الجولان وغيرها بسبب الخطأ الفادح الذي ارتكبه وزير الدفاع، عندما أذاع بلاغاً أعلن فيه سقوط القنيطرة ولم تكن قد سقطت ثم أصدر أوامره إلى الجيش السوري بالانسحاب كيفياً فترك الضباط أماكنهم الحصينة جداً، وأسلحتهم الحديثة، وفروا في كل اتجاه حتى إن قائد الجبهة العقيد أحمد المير هرب على ظهر حمار واستولت إسرائيل على جميع الأسلحة الموجودة في الجبهة من مدفعية ثقيلة ودبابات حديثة لم تستعمل ووثائق سرية"، ويمكن الرجوع لتفاصيل الكارثة في كتب أخرى مثل كتاب سقوط الجولان لخليل مصطفى، وإذا يسر الله سأكتب عنه مراجعة منفصلة.
وانتهى الكتاب عند تغلب حافظ الأسد على خصومه وعلى رأسهم صلاح جديد وقيامه بما أسماه الحركة التصحيحية في 1971، ليتولى الرئاسة قرابة الثلاثين عاماً، ومن بعده بشار لأكثر من عشرين عاماً، عاشت فيها سوريا حقبة سوداء لا يكفيها كتابٌ واحد لسرد تفاصيلها المروعة، وعلى ما شاب تاريخ سوريا الحديث من أنظمة متعاقبة تطيح ببعضها البعض، فقد سيطر الأسد على مفاصل السلطة بيدٍ من حديد، رغم الهزات العنيفة التي تعرض لها ومن ضمنها الثورة الإسلامية الجهادية عليه في السبعينيات ثم الثمانينيات، ولكنه قمعها بشكلٍ غير مسبوق، وسيطر على البلاد كلها بشكلٍ عجيب خصصت له ليزا وادين كتاباً أسمته (السيطرة الغامضة).
ولو أحببت أن ألخص آرائي في الشخصيات التي ذكرتها، فإن أمين الحافظ من الواضح أنه رجلٌ لا تعوزه الشجاعة، لكنه لا تعوزه الشعارات والخطب الرنانة كذلك، وأثناء توليه الرئاسة زايد على عبد الناصر وعلى جميع القادة العرب فيما يخص تحرير فلسطين، أما أحمد أبو صالح، فكان من الشجاعة بأن أقر أكثر من مرة بمسئوليته هو ورفاقه البعثيين عن الوضع الذي وصلته سوريا، وذكر بحسرة أنه فهم متأخراً أن حزب البعث ليس أكثر من منصة للشعارات القومية والوحدوية الفضفاضة، لكنه لم يكن سوى وسيلة يصل بها العلويون للسلطة، أما النحلاوي فيبدو عليه أنه عسكري منضبط، لكنه أقدم هو ورفاقه على السير في طريقٍ لم يروا نهايته.
وإلى هنا أنهي هذا الملخص لتاريخ سوريا الحديث، وقد يكون هذا الكتاب ليس أفضل ما يقرأه القاريء في موضوعه، بل ويحتاج المرء للاطلاع على الكثير من الدراسات والكتب الأخرى التي يكثر الاستشهاد بها مثل كتب باتريك سيل، وكذلك المذكرات الشخصية لقادة المرحلة، لكن الكتاب يتيح للقاريء معرفة الخطوط العريضة لخمسين عاماً من تاريخ سوريا أوصلت الأمور لما صارت عليه في الخمسين عاماً اللاحقة، والتي انتهت بانهيار النظام وسقوطه وانتصار الثورة السورية العظيمة، لتبدأ سوريا فصلاً جديداً من تاريخها، نسأل الله أن يوفق فيه أهلها لأن يتجاوزوا جراح الماضي، وألا يكرروا أخطاءه.